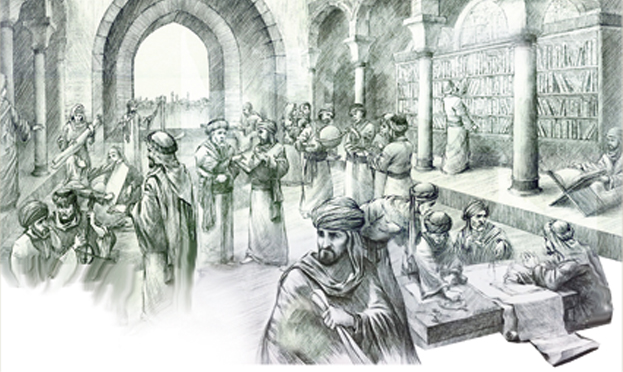أحمد كاظم نصيف
الاستشراق مدرسة فكرية ذات خصائص ودوافع وغايات، وليس من اليسير على أي باحث أن يحيط بأسرار هذه المدرسة وأن يستكشف كل خطواتها، وأن يلم بأهدافها، وهي وليد صراع طويل بين الحضارتين الاسلامية والنصرانية، وهي نتاج تجربة حيَّة من نقائض وتباين بين عقيدتين وثقافتين وحضارتين(1)، والاستشراق بمفهومه الاصطلاحي الضيق يعني “اهتمام العلماء الغربيين بالدراسات الاسلامية والعربية ومنهج هؤلاء العلماء ومدارسهم واتجاهاتهم ومقاصدهم”(2).
حدد قاموس أكسفورد الجديد المستشرق بأنه “من تبحر في لغات الشرق وآدابه، وذلك هو التفسير الذي سنعتمد عليه، وإن كان يفرض علينا أن ندع لآخرين أن يكتبوا عن ذلك الجمع الغفير من ذوي الشهرة والصيت الذين عرفوا الشرق معرفة جيدة، والذين استلهموا أدباً بديعاً، ولكنهم خرجوا عن حد التعريف السابق، فلا يستطاع تسميتهم مستشرقين”(3).
مفهوم الاستشراق لدى علماء الغرب
يقول بارت: “الاستشراق علم يختص بفقه اللغة، ولا بد لنا إذن أن نفكر في المعنى الذي أطلق عليه كلمة إستشراق المشتقة من كلمة “شرق” وكلمة شرق تعني مشرق الشمس، وعلى هذا يكون الاستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرقي، والأمر إلى هذا الحد واضح، ولكن ما معنى كلمة شرق في هذا المقام بالذات؟ الظاهر أن إسم الشرق تعرض لتغيير في معناه، فالشرق بالقياس إلينا نحن الألمان، يعني العالم السلافي، العالم الواقع خلف الستار الحديدي كما كان يسمى كذلك في الماضي، وهذه المنطقة يختص بها علماء بحوث شرق أوروبا، أما الشرق الذي يختص به الاستشراق فمكانه جغرافياً في الناحية الجنوبية الشرقية بالقياس إلينا، وذلك الاصطلاح يرجع إلى العصر الوسيط، بل إلى العصور القديمة، التي كان فيها البحر المتوسط يقع كما قيل في وسط العالم، وكانت الجهات الأصلية تحدد بالنسبة إليه، فلما إنتقل مركز الأحداث السياسية بعد ذلك من البحر المتوسط إلى الشمال بقي مصطلح الشرق برغم ذلك على الدول الواقعة شرق البحر المتوسط، كذلك تعرضت لفظة “الشرق” في أعقاب الفتوحات العربية والاسلامية لتغيير آخر في معناها، أو إذا شئنا دقة أكثر تعرضت لاتساع في نطاق مدلولها، فقد إنطلق الفاتحون في ذلك الوقت من شبه الجزيرة العربية لا ناحية الشمال والشرق فحسب بل إلى ناحية الغرب كذلك، وزحفوا في غضون عشرات من السنين إلى مصر وشمال أفريقيا وتعرب السكان تدريجياً، وهم الأقباط في مصر والبربر في غربها، ومنذ ذلك الحين تعد مصر وبلدان شمال إفريقيا ضمن الشرق ويمتد الاستشراق إلى الشمال غرب أفريقيا الذي يسمى بالمغرب أي بلد غروب الشمس، وإن كان المفروض أن إسم الاستشراق يختص بالبلدان الشرقية دون غيرها، ومهما يكن من أمر فإن الاسم لا يبين بوضوح مستقيم المقصود منه بالضبط والمهم هو الموضوع ذاته”(4).
ويعرف جويدي علم الاستشراق وصاحبه قائلاُ: “والوسيلة لدرس كيفية النفوذ المتبادل بين الشرق والغرب إنما هو “علم الشرق” بل نستطيع أن نقول إن غرض هذا العلم الأساس ليس مقصوراً على مجرد درس اللغات أو اللهجات أو تقلبات تاريخ بعض الشعوب كلا، بل من الممكن أيضاً أن نقول أنه بناءً على الارتباط المتين بين التمدن الغربي والتمدن الشرقي ليس علم الشرق إلّا باباً من أبواب تاريخ الروح الانساني، وليس صاحب علم الشرق الجدير بهذا اللقب بالذي يقتصر على معرفة بعض اللغات المجهولة أو يستطيع أن يصف عادات بعض الشعوب، بل إنما هو من جمع بين الانقطاع إلى درس بعض أنحاء الشرق وبين الوقوف على القوى الروحية الأدبية الكبيرة التي أثرت على تكوين الثقافة الانسانية، هو من تعاطى درس الحضارات القديمة ومن أمكنه أن يقدر شأن العوامل المختلفة في تكوين التمدن في القرون الوسطى مثلاً أو في النهضة الحديثة، وعلم الشرق هذا علم من علوم الروح Science de Lespirit يتعمق في درس أحوال الشعوب الشرقية ولغاتها وتاريخها وحضارتها ثم يستفيد من البحوث الجغرافية والطبيعية أن يسمى كما أسميناه درس تاريخ الروح الانساني من جهة الشرق، لأن إظهار قوى الروح واستعدادها يختلف باختلاف الزمان والمكان”(5).
ويمضي رودنسون في دراسته لتاريخ الاستشراق قائلاً: “وهكذا ولد الاستشراق وظهرت كلمة مستشرق في اللغة الانكليزية حوالي العام 1779، كما دخلت كلمة الاستشراق على معجم الأكاديمية الفرنسية في العام 1838، وتجسدت فكرة نظام خاص مكرس لدراسة الشرق، ولم يكن المتخصصون بعد من العدد بحيث يمكنهم تشكيل جمعيات أو مجلات متخصصة في بلد واحد أو شعب واحد أو منطقة واحدة من الشرق، ومن الناحية الأخرى، كثيراً ما كان أفق هؤلاء المستشرقين يشمل عديداً من المجالات بطريقة غير متوازنة في عمقها، ومن هنا بدأ تصنيفهم “كمستشرقين” وشهدت فكرة الاستشراق تعمقاً كبيراً إلى أنها تعرضت كذلك لأضرار وندوب، وكان الشرق يأخذ مكانه في مؤلفات القرن الثامن عشر إلى جانب الغرب في أفق شمالي”(6).
ويرى ديتريش أن “المستشرق هو ذلك الباحث الذي يحاول دراسة الشرق وتفهمه ولن يتأتى له الوصول إلى نتائج سليمة في هذا المضمار ما لم يتقن لغات الشرق”(7).
بعد إمعان النظر في الآراء التي صاغها علماء الاستشراق أنفسهم نستطيع أن ننتهي إلى نتائج ذات دلالات بالغة لينفذ منها إلى تقرير الحقائق التالية:
أولاً: إن دارس موضوع الاستشراق يجب عليه قبل كل شيء أن يحدد مفهومه ويحاول إيصال معناه محدداً إلى قارئيه.
ثانياً: إن الاستشراق علم ذو حدود واسعة وأحياناً غير واضحة، إذ يختلط ميدانه بميادين العلوم الأخرى لأن المستشرق قد يشارك في أبحاثه علماء الآثار والأصوات، والاشتقاق، والحفريات، واللاهوت والفنون والفلسفة وما شاكل ذلك.
ثالثاً: إن المفهوم العلمي لكلمتي “الاستشراق” و“المستشرق” قد مرَّ بأدوار مختلفة منذ عام 1783، عندما كان يعني أحد أعضاء الكنيسة الشرقية إلى عصرنا هذا حيث أصبح يعني التبحر في إحدى لغات الشرق وآدابها، فكأن هذا التبحر شرط أساس في عالم الاستشراق لأنه لا يمكن أن يأتي بنتائج علمية سليمة إطلاقاً، وإلّا بذلك كما هو واضح عند آيري وديتريش.
رابعاً: إن كلمة الاستشراق ذات دلالتين، أولهما إنه علم يختص بفقه اللغة ومتعلقاتها على وجه الخصوص، وثانيهما إنه علم الشرق أو علم العالم الشرقي على وجه العموم فعلى هذا الأساس يشمل كل ما تعلق بمعارف الشرق من لغة وآداب، وتاريخ وآثار، وفن وفلسفة وأديان وغيرها من علوم وفنون.
خامساً: إن الاستشراق علمياً يرجع إلى العصر الوسيط، بل إلى العصور القديمة، وأن مدلول لفظ “الشرق” تعرض لتغيير خطير بعد إنطلاقة العرب حتى أصبح يتعلق بالموضوع ذاته أكثر منه بالمنطقة الجغرافية، ويفتح آفاقاً واسعة للتفكير والبحث، والتحليل كما هو بين في آراء نولدكه وبارت.
سادساً: إن كلمتي “الاستشراق” و“المستشرق” علمياً حديثتا العهد نسبياً في الانكليزية والفرنسية إذ تبنتها الأولى حوالي عام 1779، وتبنتها الأخرى عام 1799، وإعترفت بهما الأكاديمية الفرنسية المشهورة بالحيطة في إدخال الكلمات الجديدة إلى اللغة الفرنسية فأدخلتهما إلى معجمها المشهور عام 1838.
سابعاً: إن الاستشراق كفكرة علمية قد نال حظاً عظيماً في أثناء القرن الثامن عشر، حيث كان الشرق يأخذ مكانه في أبحاثه ومؤلفاته إلى جانب الغرب في أفق شمولي، كما يؤكد ردونسون، مما يدل فيما نظن على أن دراسة العرب وما يتعلق بهم كان وما يزال أمراً بالغ الأهمية لعلم الاستشراق ودراسته.
ثامنا: إن الاستشراق في مفهوم جويدي أخذ ظلاً جديداً، إذ أصبح إطلاقه لا يقتصر على معرفة إحدى اللغات المجهولة للغرب والعادات الغربية عليه، وإنما على الجمع والانقطاع إلى دراسة الأنحاء المختارة من الشرق، والوقوف على قواه الروحية وآدابه العظيمة التي أسهمت إسهاماً فعالاً في تكوين ثقافة العالم بأسره، وتعاطي دراسة الحضارات القديمة والتمكن من تقدير العوامل المختلفة التي أثرت في تكوين تمدن القرون الوسطى والنهضة الحديثة، وأهمية هذا العلم تكمن في وسيلة فعالة لدراسة النفوذ المتبادل بين العالمين، الشرقي والغربي، وأنه على هذا الأساس يغوص في أعماق دراسة الشعوب الشرقية وكل ما يتعلق بها، وإذا كان الأمر كذلك فإنه يعد من أوسع العلوم موضوعاً وأبعد مدى، ولذلك يحق للباحث أن يسميه علم تاريخ الروح الانساني لأنه قوى الروح واستعدادها للتحولات التاريخية تختلف باختلاف الزمان والمكان، ويبدو أن هذا العلم في نظر جويدي يعد من أهم العلوم الانسانية وأخطرها، سواء فيما يتعلق بالموضوع نفسه أو فيما يتعلق بالتعرف على الروح الانسانية وتبادل النفوذ بين العالمين المتصارعين عبر التاريخ(8).
مفهوم الاستشراق عند العرب
وأما علماء العرب فقد ذهبوا في فهمهم للاستشراق مذاهب عديدة لا بد من الاشارة إلى بعضها، يقول أحمد حسن الزيات: “يراد بالاستشراق اليوم دراسة الغربيين لتاريخ الشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومه وعاداته ومعتقداته، وأساطيره، ولكنه في العصور الوسيطة كان يقصد به دراسة العبرية لصلتها بالدين ودراسة العربية لعلاقتها بالعلم، إذ بينما كان الشرق من أدناه إلى أقصاه مغموراً بما تشعه منائر بغداد والقاهرة من أضواء المدنية والعلم، كان الغرب من بحره إلى محيطه غارقاً في غياهب الجهل الكثيف والبربرية الجموح”(9)، ويذهبا أحمد الاسكندري وأحمد أمين في تعريفهما للمستشرق بأنه “كل من تجرد من أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقية، وتقصي آدابها طلباً لتعرف شأن أمة أو أمم شرقية من حيث أخلاقها وعاداتها وتاريخها وديانتها أو علومها وآدابها، أو غير ذلك من مقومات الأمم، والأصل في كلمة “مستشرق” أنه صار شرقياً، كما يقال “إستعرب” إذا صار عربياً” (10)، ويتوسع علي العناني في فهمه للاستشراق فيقول: “من صيغة هذه الكلمة تعرف أن المستشرق هو المشتغل بالعقليات الشرقية سواء أكانت سامية أو غير سامية، ولكن هذه الكلمة في إصطلاح العلماء والأدباء تطلق على المشتغل بالعقليات السامية خاصة، ويتبع ذلك البحث في اللغات” (11).
هوامش الجزء الأوّل:
- محمد فاروق النبهان، الاستشراق ـ تعريفه ـ مدارسه ـ آثاره، ص11، منشورات المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة، ايسيسكو، 2012م.
- المصدر نفسه.
- آ. أربري، المستشرقون البريطانيون، ص 7/8، ترجمة محمد الدسوقي، مطبعة وايام كولتر بلندن 1946م.
- ر. باريت، الدراسات العربية الاسلامية في الجامعات الألمانية، ص11/12 ترجمة مصطفى ماهر، دار الكتاب العربي، القاهرة 1967م.
- م. أ. جويدي، علم الشرق وتارخ العمران، الزهراء، 1970م، 1347هـ، ص11/14.
- رودنسون، صورة العالم الاسلامي في أوروبا، الطليعة، 1970م، ص74.
- ديتريش، الدراسات العربية في المانيا، ص7 دار نشر فرانز تناينر بنسيادان، 1962م.
- أحمد حسن الزيات، تاريخ الأدب العربي، ص512، ط25.
- أحمد الاسكندراني وآخرون، المفصل في تاريخ الأدب العربي، ج20، ص408.
- علي العناني، المستشرقون والآدب العربي، الهلال، ج10، ص40، 1932م.
- أحمد الشرباصي، التوصف عند المستشرقين، ص6، سلسلة الثقافة الاسلامية، مطبعة نور، 1966م.