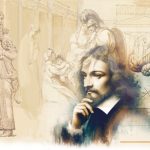علي حسن الفواز

مثقفون ثوار، او مثقفون صعاليك، او مثقفون متمردون، او مثقفون حكوميون، أو مثقون مدنيون، او حزبيون او مثقفون طليعيون ورجعيون ومتملقون. ثنائيات اشكالية على مستوى التوصيف، او على مستوى الوظيفة، فبقدر ما تعكسه من “تعليق” دلالي للوظيفة الثقافية، فإنها ليست بعيدة عن التشيؤ، ولا عن صراع المثقف مع التاريخ، والسلطة والمقدّس والنظام الطبقي والايديولوجيا، إذ كثيرا ما تتحول تلك الصراعات الى مجالات لصناعة صور للمثقف العنف والمتطرف والثوري، وحتى المثقف “الصعلوك” فضلا عن عن تحولها الى ممارسات واجراءات تدخل في سياق توصيف الثقافي المحلي، أو الثقافي الايديولوجي أو المثقف الديني، والتي سرعان ما تتحول الى علاقات طاردة، أو الى اقنعة للمخاتلة، أو الى ظواهر تسوّغ الاستحواذ والخضوع، وربما التورط بانتاج تمثلات وولاءات وأوهام مفخخة، رغم أن البعض حاول تنميطها كعلاقات عامة، او عبر ربطها بمؤسسات السلطة، أو الجماعة، او جعل منها “وظيفة سيميائية” تعتاش على اوهام التعالق المخبوء في الذاكرة الملعونة، والتي تقوم على تحويل وظيفة الثقافي الى وظيفة للحماية العقائدية والايديولوجية، أو الى نوع من الهيمنة المقدسة على الآخر، او الى اجراء قمعي يقوم على أنسنة فكرة العصاب والرقابة، او التحوّل الى سلوك شعبوي، وصياني يبرر شرعنة الطاعة والسيطرة والرقابة، والدفاع عن النزعات الدوغمائية المغلقة، بوصفها نزعات يتغالى فيها المقدس، ويصعد معها الهامش الحاكم، مثلما تصعد فيها القوى الطاردة للآخر، بما فيها الآخر الثقافي والمدني..
تقوّض الحياة المدنية في العراق، ارتبط بصعود نمط استحواذي للدولة الامنية، والدولة العسكرية والدولة الايديولوجية، والتي لعبت دورا خطيرا في “تهميش” الطبقة الوسطى المتعلمة، وجعل الوظائف الثقافية والاجتماعية وحتى النقابية جزءا من “الخدمات الحكومية” عبر عملية فرز قسرية وواهمة بين مثقف القبيلة/ الحكومة، وبين مثقف المعارضة، وهي ثنائية ماكرة وخادعة، وبعيدة عن التوصيف الحر للفاعلية الاجتماعية، او حتى للقيمة العضوية للمثقف أو للنقابي، إذ إن صورة المثقف المعارض، تحولت الى رهينة لصورة المثقف المقموع والمطرود والسجين والمهاجر والضحية، والتي هي نظيرة لبنية تاريخية لاوعية، تتمثلها صورة المثقف الزنديق والمارق والكافر والملحد، بوصفها صورة للمثقف المعادي للنسق.
صور المثقف قد تتعدد، وتتغير، لكن صورة المثقف “الرسمي” ستظل هي الصورة المكررة في التاريخ، إذ لا توجد سلطة بدون “مثقفين” يمثلون وظائف الواعظ والفقيه والمعلم وكاتب الديون، والخبير وغيرها، وحتى صورة المثقف المعاصر لم تكن بعيدة عن التطويع، فبقدر ما نتحدث عن المثقف الثوري والمثقف النقدي وحتى المثقف العضوي، فنحن أمام صورة نقيضة للمثقف الانتهازي، والمنافق والرجعي، وهذه الثنائية راكزة في المخيال الشعبوي والسلطوي، وعبر تمثيلات تبدأ من الحديث عن مثقف القبيلة –حكيمها، راويها، شاعرها- في الديوان وفي مدائح الكرم والحرب، وليبدو وكأنه جزء من بنية السلطة، ومن ادلجتها، ومن خطابها الذي تتغذى فيه الصورة المثالية للبطل، والمؤمن، والقائد، وليس انتهاء بصورة المثقف العصابي، والذي انوجد أنموذجه في الذاكرة العراقية عبر مستويات متعددة، بدءا من المستوى المدحي، الى المستوى الايديولوجي، والى المستوى الاشباعي، والذي تكرّس في الحرب، وفي البنية النمطية للسلط، في مؤسساتها، وفي خطابها، وفي صناعة سردياتها، واشاعاتها وفاعلياتها الثقافية، وهو ما تحدث عن ظاهرته الشاعر سركون بولص في لقاء اجراه الشاعر هادي الحسيني، وهو يصف هذه الثنائية المضللة، “أشعر بالغثيان دائما كلما تذكرت، ملتقى شعراءالسبعينات، الذي أقامته مجلة الطليعة الأدبية التي تصدرها وزارة الثقافة و الاعلام عام 1978 وتمت فيه دعوة 12 شاعراً فقط ليمثلوا جيلهم. لماذا؟ لأن الوزارة العتيدة تعتقد أن الآخرين ينتمون أو يتعاطفون ايديولوجياً ومعرفياً مع جهات أخرى خارج فلك السلطة، وهكذا تتم عملية الاقصاء والتعتيم حتى لا تظهر السلطة الحاكمة فقيرة ابداعياً بشعرائها الذين كرستهم وأغدقت عليهم العطايا السخية ورسختهم من خلال وسائل اعلامها الكثيرة ومهرجاناتها ووظائفها واصداراتها”
تغوّل السلطة والمثقف
تغوّل بنية السلطة في الاجتماع الثقافي والسياسي، أسهم الى حد كبير في تغوّل مثقفها، عبر استقوائه بها، بوصفه ظاهرتها الصوتية، وجزءا من مخزنها، ومقدسها وقاموسها.
تغوّل “مثقف السلطة” ارتبطت بالنزعة الاشباعية، كتمثيل لقوة الاشباع النفسي والايهامي، فهو صوّات الحرب” وحكواتي الجماعة، مثلما هو الفاعل في صناعة المنصات التي لا تنفصل عن نظام تسويق المؤسسة الحاكمة، ومن فقهها ومن جهازها الاعلامي والأمني.
هذا المثقف، هو ذاته المثقف المتحول في اطار تحول الوظائف، فهو مثقف الحرب والحزب والرقابة، والراية كما سمّاه فوزي كريم، وأية مراجعة لتاريخ العراق السياسي منذ الستينات، سنجد ارتباط عنف الظاهرة الثقافية عميقا بعنف الظاهرة السياسية والايديولوجية، إذ اصطنعت احداث الانقلابات العسكرية والسياسية في العراق كثيرا من المنصات التي يديرها مثقفون، كان خطابهم بمستوى ادوات الانقلابي عنفا واقصاء للآخر، وحتى للتعاطي مع الظواهر الثقافية وتحولاتها واسئلتها، ومستوى مقارباتها لمفاهيم التحديث والتجديد، ومن يقرأ ملفات الثقافي في ” الموجة الصاخبة” لسامي مهدي، و”الروح الحية” لفاضل العزاوي، و”تهافت الستينيين” و”ثياب الامبراطور” لفوزي كريم، و”انفرادات الشعر الستيني” لعبد القادر الجنابي، سيجد أن تعقيدات الصراع السياسي والاييولوجي كانت تُخفي في انساقها كثيرا من اشكال الصراع والرعب الثقافي، ولظاهرة الاستحواذ الثقافي، من خلال تضخم ظاهرة “مثقفي الأدلجة” أو “مثقفي الراية” كما سماهم فوزي كرين، حيث روجوا لخطاب الكراهية، واقصاء الاخر، او اخضاعه قسريا الى توصيفات ونعوت لصور “المثقف الخائن، والمثقف الملحد، او المثقف الشيوعي الملتزم والثوري باحالاته الرمزية..
الظاهرة الشعرية العراقية- رغم اهميتها الثقافية- هي الظاهرة الأكثر تعرضا للتشويه، إذ ظلت تعيش قلقها النقدي بجوار مايصنعه الرعب السياسي والايديولوجي، وعلى نحوٍ ينطوي على استيهامات غرائبية، يلجأ عبرها البعض الى الهروب الرمزي، او المشاهرة بالكراهية، او البحث عن تعويضات عبر التماهي مع تعنيف الآخر، وكذلك يلجأ الى مخاتلة ما هو مسكوت عنه ومقموع، لتبدو صورة المثقف العراقي هي الاقرب الى مجاورة ثنائية “المتاهة والراية” كما وصفها فوزي كريم، حيث تهويمات الشعارات، والادلجة المفخخة، وحيث لعبة الخداع والتوريط التي وقع في فخاخها عشرات المثقفين العراقيين، الذين تماهوا مع السلطة، ومع خطابها، واوهامها، ومع حروبها الملعونة في مراحل أخرى..
اوهام المثقف..
حين تحدث الدكتور على حرب عن “اوهام النخبة او نقد المثقف” فإنه اراد وضع المثقف امام “النقد والمساءلة” ليس لتفكيك صورته، بل لفضح علاقاته الملتبسة بالسلطة، وبالواقع ذاته، لأن اكثر اوهام هذا المثقف تتعلق ” بحراسة الافكار ومعني الحراسة التعلق بالفكرة كما لو أنها اقنوم يُقدّس أو وثن يُعبد, على ماتعامل المثقفون مع مقولاتهم وشعاراتهم, مثل هذا التعامل هو مقتل الفكرة بالذات, إذ هو الذي وقف حائلاً دون تجديد العُدة الفكرية واللغة المفهومية, بقدر ماجعل المقولات تنقلب الى أضدادها في ميادين الممارسة وميادين العمل, وذلك أن الافكار ليست شعارات ينبغي الدفاع عنها, أو مقولات صحيحة ينبغي تطبيقها, بقدر ماهي أدوات لفهم الحدث وتشخيص الواقع, إنها حيلنا في التعقل والتدبر, للحياة والوجود,باجتراح القدرات التي تتيح لنا أن نتحول عما نحن عليه, عبر تحويل علاقتنا بالاشياء أو بنسج علاقات مغايرة مع الحقيقة” 1
هذه المقاربة تؤسس قراءتها على طبيعة تحولات المثقف، وعلى مدى تضخم اوهامه، وتعقيدات علاقته بالواقع، وبالسلطة ذاتها، إذ تبدو تلك العلاقة شائكة، وحذرة، لكن اخطر ما فيها هو تحولها الى رهان لاواعٍ على العصاب الايديولوجي والاشباعي، او الى لعبة في الاختفاء، أو في السقوط الفاضح، لاسيما وأنّ هذه العلاقة الاشكالية غير محكومة بقيم الحرية، والحقوق وبعمل المؤسسات المدنية، وهذا ما جعل السلطة أكثر تنمرا في صناعة الاوهام، وفي تغذية مشاعر الاشباع الرمزي، و”التطهير التاريخي” عبر الترويج لثقافة الاوهام والعصابات، و”الرسالة الخالدة” وعبر صناعة “المثقف الموظف” او “المثقف الايديولوجي” وهما أنموذجان لصور المثقف المنخرط في الحماسة والخطابة الصورية، والحلم الثوري، لاسيما، وأن استبداد السلطة في العراق وجد العنف تسويغا ل”العنف المقدس” ولطرد الآخر، بوصفه الديموغرافي والقومي والطائفي، مثلما وجدت في خطاب الثورة القومية، وخطاب التاريخ مجالين لربط الفاعلية الثقافية بالخطاب الرسمي، عبر المهرجانات الكبرى، كما كان يحدث في “مهرجان المربد الشعري” او عبر مؤتمرات لها يافطات تاريخية وقومية، او عبر جائزة “صدام” وبقيمة 100 الف دولار اميركي، وعبر دعم مؤسسات واصدار كتب ومجلات لها خطابها المعروف، وبإدارة اسماء لها حضورها الثقافي والاعلامي العربي، مثل مطاع صفدي، امير اسكندر، احمد ابو مطر، جهاد فاضل، وليد ابو ظهر وغيرهم..
هذه الاسماء ظلت تتحرك في سياق ثقافي عربي، تتغذى فيه نزعات المركزة القومية، وتتغوّل فيه صورة السلطة بوصفها التمثيلي لفكرة الأمة، مثلما تتوه فيها صورة المثقف، إذ غابت صورته النقدية، بما فيه نقد التاريخ، وغاب مشروعه الحداثي مقابل تحوله الى “مثقف اعطيات” وبقدر اشكالية هذا السياق الغرائبي الذي تموضع فيه المثقف، فإن السلطة وجدت في صناعة الفضاءات الثقافية لعبة في الهيمنة، وفي تحييد وظيفة الثقافي النقدي من جانب، وفي وريطه في غواية الغنائم الحسية والرمزية والمادية من جانب آخر، لاسيما وأن الفضاء الثقافي العربي الرث، يعيش اوهامه الكثيرة مع السلطة ومع التاريخ، ومع “المسكوت عنه في التعاطي مع اسئلة الخطاب القومي، والذي وجد في البنى العسكرية والحزبية والعصابية قوته الحاكمة والدافعة، للتماهي مع الذاكرة الملعونة، وعبر اعادة انتاج ” غرور البطل القومي” عبر دعم مؤسسات تتبنى الاهتمام بموضوع التاريخ، ودعم مؤسسات ضخمة للإنتاج السينمائي والتلفازي، مقابل تهميش صورة المثقف النقدي، اليساري، والثوري، بوصفه مثقفا ملعونا، ومسكون بهواجس البحث عن المخفي والمقموع في التاريخ.
الترويج لصور “المثقف المؤرخ” كان نظيرا للترويج لصور”المثقف العرّاب” و”العارف” و” المؤسس” وصولا الى صور “المثقف المُلفّق” و”المثقف الوصولي” والمثقف الاستعراضي” و”المثقف كاتب التقارير” وهي ظواهر لم تتحرر من عقدة التاريخ والايديولوجيا، او من الصور الذاكراتية لمثقف الأعطيات والغنائم.
هذه النقائض “القاتلة” صنعت لها هامشا مفضوحا، عبر عديد المؤتمرات والمهرجانات والندوات والحلقات الدراسية، ولم تستطع أن تقارب الاشكاليات الصراعية العميقة في المشهد الثقافي العراقي، فهذا المشهد محكوم ومنذ نهاية الاربعينات بعوامل ايديولوجية وسياسية، وحتى طبقية” وأن نشوء السلطة المستبدة، اسهم في تشويه تلك العوامل، ليبدو الصراع وكأنه بين ثنائية “المقدس والمدنس”، عبر اللجوء الى خيارات تحضر فيها “المتاهة” وحسب توصيف فوزي كريم، حيث النكوص الى الذات ورهابها الداخلي، وحيث الاحساس بالخسارة والفقد، والانزواء والهروب الى مناسك تلك الذات الجريحة والمهزومة، مقابل لجوء البعض الآخر الى “الراية” للتعبير عن الهوس بتضخيم الذات، بوصفها ذاتا سلطوية، مسكونة بشهوانية عنفها “المقدّس” والتي تكرست كمجال “حيوي” كرست من خلاله السلطة المستبدة فرضية سيطرتها الرمزية على “الصناعة الثقافية” مثلما هي سيطرتها على “الصناعة السياسية” وعبر وسائل الترهيب والترغيب، وهو ما أشار اليه الناقد حيدر سعيد، في مقاربته لتبعية المثقف العراقي للسياسي، او للحاكمية السياسية بمعنى ادق، بعيدا عن أية مراجعة، او اجراء نقدي، فالبعث العراقي ألحق مثقفيه بجهاز الدولة من خلال “تبعيث” منظم للدولة العراقية، فتحوّل المثقف من تابع للسياسي إلى تابع للدولة، ومن أداة أيديولوجية للحزب إلى أداة أيديولوجية للدولة. ويرى سعيد أن إعادة صوغ علاقة المثقف بالدولة في عراق مابعد عام 2003 كانت مخاضًا للمثقف العراقي اللادولتي كي يعيد تعريف هويته ووظيفته.
رهاب التاريخ، رهاب المؤسسة.
ثمة من يقول بأن اللغة هي “ترياق عظيم” وهناك من يستعير مقولة هيدغر عن البيت اللغوي. هذا التوصيف يمنح اللغة طاقة استثانية لمواجهة رهابات التاريخ والمؤسسة والايديولوجيا والعصاب، عبر الاختباء الاستعاري، او عبر التوريات الساحرة، او عبر “التملّق” وهو توصيف اجرائي واجتماعي لممارسة “الطاعة” اللغوية، عبر توظيفها، او جرّها الى سياقات غير ثقافية، اقصد سياقات التاريخ والمؤسسة، وعلى نحوٍ جعل البعض يعيد انتاج ظاهرة المثقف المناسباتي، والمثقف الوصولي..
هذه الاستعادة لا تعني غياب “المثقف النقدي” الذي يحمل معه صورة “المثقف التظاهري” الذي يجد في التظاهرة الشعبية، وفي الاحتجاج، وفي شعارات الرفض والثورة، مجاله التمثيلي للتعبير عن ازمته مع التاريخ ومع المؤسسة، وحتى مع الدوغمائيات الحاكمة تاريخيا ومؤسساتيا، وأحسب أن متغيرات الواقع العراقي ما بعد عام 2003 تكشف عن صعود العصاب الطائفي، وعن تمرد قوى “السلطة القديمة” و” الهوس القومي” الذي كانت تغذي “ثقافويته” سلطة الاستبداد، لكن فشل القوى الجديدة في التعاطي مع مفاهيم الدولة والحرية والديمقراطية والصناعة الثقافية، اسهم في تشظية المسارات، وفي تعمية “الصناعة الثقافية” إذ تحولت هذه التعمية الى صناعات ملتبسة لمؤسسات رثة، والى صور غرائبية للمثقف الطائفي، والمثقف الرجعي، والمثقف الاستيهامي.
تعدد صور أزمة المثقف العراقي، في مرحلة ما بعد 2003، من خلال أزمته مع الاحتلال الاميركي، ومفاهيم الوطنية والهوية، وصولا ازمته مع المؤسسات الثقافية، والامكانات المحدودة والرثة لصناعة المشروع الثقافي، وربطه بالتنمية والبناء الدولتي، ومع البحث عن مجال ثقافي يمكن للمثقف أن يمارس من خلاله دوره النقدي في مواجهة مظاهر النكوص والانسداد السياسيين، في سياق مواجهة الفشل السياسي، والتصدي للمرجعيات الثقافية للفكر الارهابي التكفيري، وكلّ مظاهر العنف بأشكاله المتعددة..
من جانب آخر، وفي مرحلة لاحقة برزت صورة أخرى للمثقف التظاهري بعد تظاهرات 2011، واحداث تشرين، بوصفها تمثلات للمثقف الفاعل في مجال الاحتجاج الوطني والثقافي، لكن محدودية أثر هذه التظاهرات، واختراقها من قبل جماعات معينة، جعلها اقل تأثيرا، وربما وقع بعضها في سياق انفعالي، افقدها الوضوح والواقعية، وبالتالي فقدت شرطها الموضوعي في أن تتحول الى قوة حاكمة، إذ وظفها البعض لممارسة الانتهازية السياسية، والاستعراضية، واخفى وجهه النقدي تحت ترميزات بلاغية ملتبسة، فيها من المراهقة الثقافية اكثر مما فيها من الواقعية السياسية، ومن الوعي بعلاقة التظاهرات والاحتجاجات بأزمة النظام السياسي في العراق الجديد.
ازمة المثقف العراقي وتعدد صوره جعلت من ازمة المثقف، وازمة المؤسسة، تحمل نُذر خطيرة، للعودة الة ما يشبه مركزة الاجتماع السياسي بوصفه الاحتوائي، وبأدواته القائمة على تعطيل ارادة التفكير النقدي، مقابل تشظي وظائف المثقف النقدي بوصفه فاعلا اجتماعيا، وصانعا استثنائيا للحجاج الوطني، ولقوة الرأي العام، ولاستشراف تحولات بناء “الدولة المدنية” والتي تمثل مشروعية التأهيل الإطاري لعمل المؤسسات الفاعلة في الثقافة والتعليم والصحة والقانون والخدمات والمعرفة وفي دعم برامج التنمية المستدامة في مجال الحريات والحقوق، بما فيها حقوق المرأة والطفولة والشباب، عبر ايجاد “المجالات الحيوية” للانتاج والتواصل، فضلا عن دعم برامج الصناعات الثقافية بدءا من الكتاب والفيلم السينمائي والدرامي والمسرح وصولا الى دعم الصناعات الثقافية الرقمية، بوصفه قوة عابرة للخصوصيات.
إن مواجهة تاريخ “محنة المثقف العراقي” تبدأ من التخطيط الثقافي، ومن اعادة تأهيل المؤسسات الثقافية، لمواجهة التضخم الغرائبي لمؤسسات التشوه السياسي، وعدم استقرار تداولية مفاهيم الحرية والديمقراطية والسلم المدني، والتي تغولت طثير من مظاهر هذا التشوه لتضعنا امام نكوصات سياسية متوالية، وأمام واقعيات رثة، تقودها فاعليات سياسية اكثر رثاثة، لا تأبه بالنقد، ولا بالاحتجاج والتظاهر. من هناك ندرك اهمية الحلول الثقافية، ليس بوصفها حلولا ابدالية، بل لتغذية المسؤولية النقدية، ولايجاد الاطر العقلانية التي من شأنها تفعيل دور المثقف النقدي، عبر تنويع المنصات، وعبر الانفتاح على الاجيال الجديدة، وعبر قراءة خطاب التظاهرة بوصفه خطابا للتغيير وليس للاحتجاج فقط…
- د. علي حرب/ اوهام النخبة او نقد المثقف/ المركز القومي العربي/ بيروت- الدار البيضاء/2004