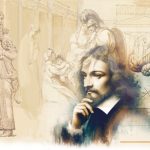ماهية تكونها وغاياتها
د. نادية هناوي

(النسوية الإسلامية) حركة سياسية ظهرت مطلع تسعينيات القرن العشرين مع المد الإسلامي المتشدد واُختلف بشأن ماهية تكونها وغاياتها. وكثير من الباحثات اللائي انجررن وراء هذا التوجه وانتمين للنسوية الإسلامية، لم يحققن على المستوى الثقافي، سوى مزيد من تبرم الرأي العام من إسلاميتهن التي هي أقرب إلى الإيديولوجية منها إلى الدين، ومن ثم لا هنّ أفدن النظرية النسوية ولا هنّ عززن الصورة الإسلامية للمرأة.
إنّ من يصف هؤلاء بالمفكرات والفيلسوفات متوهم كل الوهم، فليس القول بنسوية إسلامية والدعوة إلى تحرير النساء من المظالم والقيود تعني أن هناك تفلسفا؛ بل هي آراء تطرحها الكاتبة وقد عايشت تجربة مجتمعية فيها تضييق ورضوخ أو هي مواقف تتبناها من عانت الظلم ورفضت الانقياد أو انكوت بنار الاضطهاد والحبس والإهمال والمراقبة.
وعادة ما يكون المبتغى من وراء طرح تلك الآراء واتخاذ تلك المواقف هو الإصلاح والتعايش والاحترام الذي به تتحسن الحياة. بيد أن أغلب اللائي ينادين بالنسوية الاسلامية هن مهاجرات ومغتربات قدمن من بلدان فقيرة أو محتربة أو متشددة، منفيات أو هاربات ثم اتخذن من بعض بلدان الهجرة منصات لطرح رؤاهن الفقهية بنوعيها السلفية والإصلاحية وبمنهجيات تأويلية ونفسانية أو بدون منهجيات مع كثير من التمرد والعصيان لآبائهن ومجتمعاتهن معبرات عن مظالم وكاشفات عن ممارسات تعبر عن تعاستهن وتجاربهن التي فيها ذواتهن متضادة مع الآخر المختلف، مفردا كان هذا الآخر أو جمعا ذكورا أو إناثا معرفين أو مجهولين.
ومن هؤلاء أمينة ودود التي جذبت الانتباه إليها وهي تؤدي دور الإمام في جمع من المصلين بأحد مساجد نيويورك. وهو ما أثار في حينها جدلا ولأن لها مبرراتها ألفت كتابا محوره هذا الجدل. وحظيت أسماء برلاس الباكستانية بدعم إعلامي وهي تدرس الإسلام والتأويل القرآني والمرأة والجنوسة في كتابها (المؤمنات في الإسلام ) فجذت إليها الأضواء التي ما كانت لتجذبها لو أنها كانت في بلدها. أما المسائل التي ناقشتها كالأبوية والسلطوية والتميز بين الجنسين وأفضلية الرجل انطولوجيا وأخلاقيا واجتماعيا فليست محظورة؛ بل هي معتادة ومطروقة ومن يطالع الصفحات الثقافية للصحف اليومية أو الأسبوعية في البلدان العربية والإسلامية فسيجد بين الفينة والأخرى أكثر من مقال أو دراسة تصب في هذا الباب.
ومثلها مواطنتها رفعت حسن التي احتلت مكانا في النسوية الإسلامية وهي أكاديمية ولها أبحاث في فكر محمد إقبال والنساء في الإسلام والإسلام المعاصر. وكذلك ايان حرسي الصومالية ونسوة أخريات لم يقمن سوى بإسقاط سيرهن الحياتية وتجاربهن الخاصة على المجموع النسوي الإسلامي، وهن يتحدثن عن الفقر واضطهاد الأقلية والكبت الجنسي والعنف المنزلي والزواج القسري. وما يؤاخَذن عليه هو التطرف في بعض الآراء إلى درجة المغالاة والإلحاد أو ربما الارتداد بالعصيان وإشاعة الاسلاموفوبيا، وما لذلك من مردودات سلبية على المرأة المسلمة كونه لا يعالج شرخا، وإنما يزيد في تعميق الشرخ والتداعي، فتتعالى المعاداة للنسوية وقد تسفه أهدافها وتهضم حقوقها ويتهاون في الاستجابة لمطالبها ويشكك في ما تدعو إليه من مسائل لها علاقة شرعية وحقوقية بالإرث والشهادة والزواج والطلاق والحجاب.
وبالطبع فإن المرأة التي تدعو إلى إصلاح واقع تعايشه وتتحمل أتونه غير التي تنادي وهي محتمية بالغرب. ليس من باب أن الأولى تكافح مناضلة ولا غاية نفعية ترتجيها من واقعها المرير؛ بل لأن الثانية تنادي بإصلاح ولها وراء ذلك مآرب أخرى تدلل عليها المواقع التي تحتلها وفرص التوظيف والعمل والقبول في مراكز بحثية أو على الأقل الظفر بالشهرة التي بها تحقق مآلات كانت ترتجيها.
وهذا ما يثير الأسئلة حول مدى صدق نوايا الباحثات في النسوية الإسلامية كما يجعل الارتياب يتسرب إلى الأذهان حول حقيقة ما ينشدنه من وراء تمردهن ونقمتهن، أهو الإصلاح والتغيير أم هو شيء آخر ؟ لاسيما إذا علمنا أن أغلب المنضويات في النسوية الإسلامية يعملن الآن في مؤسسات أكاديمية مرموقة في أوربا وأمريكا ناهيك عن حقيقة ما مرت به بعض الداعيات الى هذه النسوية من ظروف تعيسة أدت بهن إلى أن يكن ناقمات على المبادئ ومتمردات على آبائهن ومجتمعاتهن. وإجمالا لم تجنِ النسوية شيئا من هذا كله؛ بل ظلت المنفعة مقصورة في إطار ذاتي، سعيا وراء الشهرة وجذبا للأضواء وربما الخضوع لدوائر معينة تروج لهن وتدعمهن في الخفاء.
ولو أن النسوية الإسلامية انطلقت من بعد فكري لا سياسي واعتمدت منهجا معتدلا لربما حققت ما أرادت تحقيقه، مفيدة من الرؤى والنظريات الاجتماعية والنفسية، منتقدة السلطة الذكورية المهيمنة على مختلف مجالات الحياة بنظم رمزية لها صلة بالثقافة واللغة والعقل كما أن فيها كثيرا من التحريف والتشويه. وبعض اللواتي أردن أن يظهرن بمظهر المتحررات لم يكنَّ من الإسلام في شيء؛ بل كن ضده، وبعضهن الآخر كان تبعاً للذكورية في النظر للمرأة، موطدات بقصد أو من دون قصد مآرب التمركز الذكوري لكنهن أيضا حققن لأنفسهن في ظرف وجيز شهرة ما كن يحلمن بتحقيقها. وعلى الرغم مما أخذته( النسوية الإسلامية ) من صدى إعلامي وما لاقته من دعم؛ فإنها لم تفد النساء ولم يكن لها أي أثر في واقع المرأة الاجتماعي والثقافي الراهن، والسبب التضخيم المقصود والمتحيز الذي يتظاهر بالوقوف إلى جانب المرأة بينما هو يعاديها في الصميم.
هكذا غدت النسوية الإسلامية صورة مفبركة لأمرين: الأول/ أنها ليست من النسوية في شيء. والثاني/ أنها ليست من الإسلامية في شيء. إذ ليس المقصود من مجئ الباحثة النسوية إلى ميدان الدرس الإسلامي تعميق تفقهها الذي فيه إعلاء لقيمة المرأة في مجتمعها؛ بل هو في الغالب التمرد خرقا وانتهاكا وتجاوزا على المواضعات الإسلامية وأعرافها المجتمعية والإعلان عن عدم الاحترام والتظاهر بالشجاعة بينما الحقيقة هي البحث عن الشهرة السريعة وجذب الأضواء الساطعة. وكلما كان تمرد المرأة المنتمية إلى النسوية الإسلامية قويا وجريئا وساخنا كانت الشهرة أسرع إليها. والصدمة الأشد أن الكاتبات اللواتي انتمين للنسوية الإسلامية أغلبهن مهاجرات وجدن في الغرب ملاذا وانتمين له لاجئات ومنفيات مفيدات من حيز الحرية الشخصية والليبرالية الفكرية، من أمثال افصانه نجم ابادي ونيره توحيدي وزيبامير حسني.
والسؤال هنا هل استطاعت إسلامية هذه النسوية أن تحررها من كونها حركة سياسية ؟ وهل تمكنت الداعيات لها أن يرسِّخن ـــ بتمردهن وشطح أفكارهن ــــ موضعا لهن في تاريخ النسوية ؟ وما الفائدة التي جنتها المرأة المسلمة والنسوية العربية؟ وكيف تجني المرأة الفائدة والنسوية توجه لنفسها ضربة تطعن فيها لب توجهاتها، منفِّرة منها العموم ومضيِّقة مجالها بالتضليل والخداع والاتهام والنبذ..وليس بالتفكر والاستدلال والانفتاح والتشارك ؟.
على الرغم من محاولات( النسوية الإسلامية) نشر مسائل العقيدة التي بدت مريبة في تزامن ما نشر لداعياتها من أبحاث، فإن ما حملته من انحراف وتمرد جعل جهودهن تذهب أدراج الرياح. هذا إن لم تكن قد أساءت إلى النسوية وعزلتها في زاوية ضيقة، تتقلص فيها قيمتها الاعتبارية البحثية والفكرية مفتقدة بعضاً من احترامها، وخاسرة الموالاة العاطفية والدعم المعنوي اللذين هي بأمس الحاجة إليهما.
ونظرة متفحصة في الغايات التي بها يتم استكتاب باحثين وباحثات على وفق اعتبارات إسلامية نسوية سيظهر كيف أنّ المرأة في مثل هذا النوع من الأبحاث ليست هي الهدف كما أن النسوية قد تضيع أحيانا في خضم متاهات أيديولوجية وتوجهات عقائدية تضر بكينونتها أكثر مما تنفعها. وهو ما قد يفيد بعض التيارات والحركات التي تبغي بهذا التقييد للنسوية بالسمة الإسلامية ضرب حركات وتيارات أخرى تختلف في أفكارها معها وتتعارض معها في رؤاها.
وقد لا نجانب جادة الصواب إذا قلنا إن الدين في منظور النسوية الإسلامية هو المستهدَف أكثر من سواه، ما يجعل الإسلام يبدو بحسب توجهاتها ورؤاها كأنه دين قهر واضطهاد للمرأة وليس الدين الذي رفع الحيف عنها وأعطاها مكانتها وحررها وأعاد لها اعتبارها.
ولقد أدت بعض الباحثات الإسلاميات دورا اعتداليا وهن يدرسن النسوية بوصفها فكرا وتاريخا، ومنهن أميمة أبو بكر التي تتبعت بدايات الوعي النسوي الأنثوي في التاريخ الإسلامي مؤشرة على بعض الوقائع التي لها دلالتها النسوية، ومنها واقعة أم سلمة وأسماء بنت عميس التي تدلل على أن للمرأة مكانتها في شؤون الحياة. واقترحت دراسة الفقه وسياقاته الاجتماعية ومراجعة الآراء الفقهية التي غلبت فيها الثقافة المحلية على صريح النص أو مقاصده، وقدمت لأهلية المرأة العقلية والقانونية صورة دونية تتعارض مع صريح النص القرآني وسنة الرسول القولية والفعلية ، مؤكدة أنّ الأجندة النسوية هي في عمومها ليست متوحدة، فهناك النسوية الليبرالية والراديكالية والماركسية وهناك نسوية محافظة وأخرى دينية كما أن هناك تخصصات ومناهج متعددة تعتمد في دراسة النسوية مثل المناهج التاريخية والانثربولوجية والسياسية والأدبية النقدية وغيرها. وتتحفظ أميمة على توصيف النسوية بالإسلامية أو تسمية النسويات بالإسلاميات، والسبب برأيها أنها قد تعطي انطباعا بوجود نسوية غير إسلامية ونسويات غير إسلاميات فضلا عما قد تحدثه مثل هذه الأوصاف والأسماء من الفرقة. ومثلت بأوائل النساء المتعلمات مثل زينب فواز وعائشة التيمورية وملك حفني ناصف اللائي كن معتدلات غير متصادمات مع النهج الإسلامي .
ولا نرى فرقا بين توصيف النسوية بالإسلامية أو توصيفها بالمسلمة لأنهما في العموم يصبان في باب التماشي مع ما عُرف في بعض البلدان من ظهور نسوية يهودية ونسوية مسيحية وبغض النظر عن اختلاف المنظور والرؤية وطبيعة السياق الثقافي والحضاري الذي تنتمي إليه كل نسوية من هذه النسويات.
وما ينبغي على المرأة أن تطرحه ـ بوصفها فردا في جماعة توصف بأنها نسوية إسلامية – هو أين هي تلك النسوية التي تمثلها وهي تمقت الإسلام والمنظومة الإسلامية ؟ ولماذا تتاجر باسمها نسوية باحثة عن أهداف مشبوهة في مقدمتها الاشتهار؟ ولماذا تتناقض الأهداف مع الوسائل عند من تتحدث باسم الإسلام؟ وما نصيب المرأة في نسوية هي في الأساس محددة بخصوصية مصلحية ونفعية ؟ أليس التكميم والإدانة هما النصيب الذي به تهدر مظلوميتها ؟. وأين هي النسوية اليوم من المرأة العربية التي تعيش في الهامش عاملة وفلاحة ومعاقة ومتوحدة ومريضة نفسيا ومسجونة وفاقدة عقل الى آخره من الهوامش النسوية؟ هل تمكنت بعض النسويات العربيات من النزول ميدانيا إلى الواقع المزري الذي تكابد النساء ويلاته يوميا وحياتيا؟ هل عملن على تعميم الدور الثقافي والمجتمعي والعملي على المجموع النسوي بدل الاقتصار على نفر من النسوة او على امرأة واحدة فيها تتمثل كل النساء ؟.
إن الإجابة عن مثل هذه التساؤلات قد لا تكون دقيقة إلا في صورة باحثات نسويات يجمعن النظر بالعمل كما أن هناك باحثات هن لسن نسويات، لكنهن في عملهن كن أقرب إلى النسوية فوقفن مع من هي مهمشة ومقهورة. ومن ذلك مثلا ما أدته المرأة المتعلمة في عصر النهضة أواخر القرن التاسع من دور تنويري في مواجهة السلطة الفحولية، ممتلكة وعياً إسلامياً، به ضمنت فيما بعد بعضاً من حقوقها أمّاً وزوجة وبنتاً وعاملة.
وهناك باحثات دفعتهن موضوعات دراستهن إلى أن يكن نسويات من دون أن يقصدن ذلك. وفي هذا دليل قوي على ما ينبغي أن تكون عليه النسوية العربية. نذكر في هذ الصدد دراسة الواقع التحتي للمسجونين والمسجونات مما قامت به منى فياض في دراستها التي ابتغت منها نيل شهادة عليا، مؤكدة مقصديتها الإنسانية التي دعمتها بإشاراتها إلى فوكو وكتابه المراقبة مدللة على وعي نسوي بالمرأة التي هي نزيلة السجن. فالتفتت إلى هذه الفئة النسوية ودرست وظيفة العقاب وبروز الحساسية الجديدة ضد العنف وإرادة العدالة المنزهة من العنف وارتباط ذلك بتغيير النظرة إلى الجسد والى النفس .
ولا شك في أنّ النظرة العلمية تكسب النسوية عامة استقلالا في كينونتها، وبه تضمن الارتقاء وتحول دون أن تكون أداة من أدوات الوقوع في غلواء التطرف والانحياز وفخاخ الاستشراق والكولونيالية وسلبيات التفسير للأصول والمرجعيات وذرائعية الأهداف المبيتة بشعارات منمقة من قبيل ( تمكين المرأة / التغيير المجتمعي / رفض التمييز الجندري / محاربة العنف الأسري / مناوأة التعنيف الجسدي / مناصرة المرأة المعنّفة..) وما شاكل ذلك كثير.
بعبارة أخرى نقول إن الذي يعطي للمرأة شخصيتها ويجعلها بعيدة عن أن تكون أداة بيد غيرها هو في تجاوز التخصيص أو التقوقع والانعزال. وبذلك فقط تقترب من منظومة النماذج الاجتماعية التي تريد نقدها وتصحيحها، عاملة لصالحها وصالح بنات جنسها.
وما رفض النسوية لفكرة تسييسها سوى توكيد لحقيقة أنها لن تتخصص في مسائل ضيقة ومطلبية، قد تبعد عنها سمة التفكر في مختلف صعد الحياة وتجعلها موسومة بالتطرف والنبذ أو التعصب أو التشويه وغيرها من الصفات السلبية التي تجرّد المرأة من أحقية الحرية وترهنها بالضيق الفكري. وهو ما ينبغي للنسوية أن تقاومه بالعمومية عاملة على دعم صورتها وتؤكيد جدوى فاعليتها، فلقد تقلصت المسافات وبانت السلبيات وتحول العالم من قرية صغيرة الى بيت. ولا بد من التكاتف والتقارب بمقاييس كوزموبولتية تحسب على وفقها المسافات والعلاقات حيث كل فرد في مجموعة ما، هو جماعي في وحدته بالشراكة والتحصن والمراقبة والتعايش والتجاوز والعمل والتواصل وبأشكال جديدة ومبتكرة.
الإحالات: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المرأة والجندر إلغاء التميز الثقافي والاجتماعي بين الجنسين، د. اميمة أبو بكر ود. شيرين شكري، دار الفكر المعاصر، بيروت، ط1، 2002، ص32.
ينظر: المصدر السابق، ص47 ـ 50ـ 51.
السجن مجتمع بري، منى فياض، دار النهار، بيروت، ط1 ، 1999، ص37.