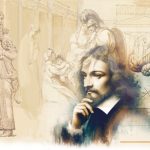الحمولات اليومية والوعي المعرفي
جاسم عاصي
نسوق الملاحظات العامّة أدناه التي تخص الشعر عموماً، إذ نجدها من المعينات لنا في قراءة قصائد الشعراء الذين تميزت قصائدهم بخصائص ذاتية وموضوعية، اكتسبت حمولاتها من المعايش اليومي، وما يزخر به من معاني شكّلت تاريخاً ساعد على رفع وتيرة الوعي المعرفي عند كل شاعر، كما شكّل خزين الذاكرة، وبتفرد واضح في ظاهرة التأمّل بما هو غير مرئي في واقع المشهد اليومي، وبهذا يساير خطى شعراء شكلوا وصمموا خارطة الشعر العراقي بما قدموه من أساليب واجتهادات في صياغات المشهد الشعري سواء بما يتناوله لليومي المؤثر في الحياة، أو في البعد المعرفي الفلسفي.
إنّ هذه الملاحقات النقدية عبارة عن رؤى تُعيننا على معرفة الشعر ووظائفه، وهي بمثابة منهج ومؤشر للقراءة التي نرمي إليها. وأولى هذه المؤشرات يخص طاقة اللغة التي تكمن في تجاوز البنية الشكلية باتجاه الحفر في امكانياتها الذاتية المستندة إلى قدرة مستعملها وتكييف مفرداتها البانية لوعي المتلقي، عبر الكشف عن مكنون اللغة نفسها، وطاقتها على تنويع ايقاع التعبير دون استهلاك ومراوغة تفتقر إلى عمق الرؤى. وهذا ما يدفع باللغة الشعرية إلى الضرب على القدرة الذاتية للشاعر في خلق الصور والتجاور مع الحراك العابر للمألوف في الصياغة المجاورة المعتمدة على بث النشاط الذهني في محاورة الظواهر والأمكنة والحس الفائق.
إنّ قيّم الشعر تنبع من الأصالة والمعرفة وبهذا يكون الشعر محرك وموسّع من مدى التعبير بشكل يفوق طاقة الشعور وطاقة الشعر، لأننا نعتقد بأن الطاقة الكامنة في اللغة عامّة تُحقق عبوراً باتّجاه لغة الشعر المتمسكة بالشعرية التي تتوفر أيضاً في نثر الأجناس الأُخرى سواء كانت حروفية أو مرئية، فهي تتجسد في طاقة كامنة في النص. من هذا يمكننا القول أنها لم تتجرد عن مكونات الشعر سوى في شكله البنائي العروضي أو البناء النثري المتماسك، إذ حققت قوة تمسكها بما ترشحه اللغة من شعرية. والدارس لنماذجها يقف على التنوع في الاستعمال للغة الشعرية، عبر العبور من تركيب المفردات الشكلي إلى التركيب الرؤيوي. فالشعر هنا لغة التأمل المدعوم برؤى فلسفية ومعرفية عامة، فاليوت مثلاً يرى في الشعر نوعاً من تحقيق التوازن والرفعة إذا ما استخدم ووظف بشكل جيد ومتوازن. من هذا نرى أن الغنائية في قصيدة النثر توفر ايقاعاً متنوعاً، شأنها شأن قصيدة التفعيلة.وهذا الايقاع الكامن في التركيب اللغوي من يخلق الفضاء الشعري، فالشعرية هنا هي مجموع السمات التي تنتقل من الكون الجمالي إلى الكون المعماري الثقافي.فالقصيدة بهذا الضرب من التسيّد بمثابة عمارة هندستها اللغة، وأبعادها الفضاء المعرفي. والقصيدة كالعمارة؛ إذا لم تكن قائمة بذاتها ومكوناتها الذاتية والموضوعية، فإنها لا تحقق عمارة متميزة كما فعلت المعمارية والمهندسة زَها حديد عبر اطلاق مخيلتها الشعرية لتكون أداة تحقيق لشعرية العمارة. فالشعرية كما ذكر المهندس أسعد الأسدي، لا تقتصر على جنس دون آخر، بقدر ما تتوزع وفق المكونات الذاتية للمشيّد، سواء للقصيدة أو العمارة. المهم تنشيط وتفعيل المتخيل الشعري لإنتاج عمارة أو قصيدة شعرية عابرة للتقليدي. إن (الشاعر، السارد، المعماري، التشكيلي، الفوتوغرافي) لا يحقق سوى ما يتخيله قائماً بذاته وبتصورات شعرية. فالثقافة أهم آليات الإبداع الشعري، التي تُعين الشاعر في اختيار منهجه المدعوم برؤى قارّة، يحاول تنميتها باستمرار بما يؤهله إلى خلق شخصيته الشعرية. فشاعر بلا معرفة موسعة يتعذر عليه كشف الكامن أو المسكوت عنه في الوجود خاصة الثقافة الجامعة والمدعومة برؤية فلسفية واجتماعية تحقق رؤى موسعة تؤثر وتعكس قوة الشعر ومساحته كجنس أكثر حساسية. فالرؤى والكشف والحفر التي يمارسها الشاعر، هي مفاهيم واجراءات تتجه نحو كشف اللامرئي والتوسيع من دائرة الشعر في وظائفه.وما نقوله بشأن الثقافة والمعرفة للشاعر، كونها أحد معالم الحداثة الشعرية. فالحداثة لا تقتصر على كتابة حديثة، خاصة قصيدة ألنثر التي تعمل على الازاحة وتأسيس البديل الرؤيوي. فقصيدة النثر مثلاً لا تعني الخروج عن قوانين الشعر المألوف والموروث، بل أنها تتمسك بقوانين مرنة، تؤسس للمفردة وظيفتها، وللجملة الشعرية فيضها. فشاعر مثل أدونيس كان قد تمكن من تأسيس مشغله الشعري، عبر تكثيف معارفه، والتزام ما يوحي به لا بما يجب أن يكون، لاسيما التوجه الصوفي. وكما ذكر الناقد إحسان عباس كون الاتجاه الصوفي هو تعويض العلاقات الروحية والغور في الذات الإنسانية. أي أنه كشاعر يتوحد مع ذاته ومكونه المعرفي من أجل صياغات جديدة ومقنعة له.ولا يقتصر هذا التبدل في صياغات فكرية كهذه، وإنما العمل على توسيع دائرة الشعر بوظائف كثيرة ومستجدة، أو كما أكد هايدجر على ربط نشأة الحداثة بالوعي الفلسفي المتمثل في جعل الذات مركزا ومرجعا. فالفلسفة لا تبتعد عن الهم الصوفي، إن لم تكن جزءاً منه في ممارسة حق الذات على اجتراح نسقها الشعري والوجودي. من هذا وغيره يضعنا بمقابل فن كتابة قصيدة النثر عند (رامبو، الماغوط، منعم الفقير) على سبيل المثال. وقد أكد أليوت على أن الاحساس بالمقطع والإيقاع يتغلغل بعيدا وراء مستويات الفكر والشعور الواعيين غائصا إلى اشد الاشياء البدائية والمنسية، مما يدفع بالشاعر إلى التطلع والاستعانة بما يكمل رؤى الشعر كالأساطير، من أجل المقارنة والمقاربة مع واقع يمتلك خصائصه السلبية والايجابية.فهي بمثابة قناع في الشعر أو غيره من الأجناس. فالشعر بهذا يستخرج كل ما يمكن استخراجه من كل ما يقف خلف الكلمة من وزن كلي للتاريخ اللغوي مندفعاً إلى أقصى حالات التحديث.فالشعر ينبع من الهم الإنساني ويوحي لنا بنواحي القصور في الوجود. إن الشعر ينهمك باللغة في محاولة الكشف عن المناطق القصية والمعتمة من صفحة الوجود.فالشاعر شانه شأن المبدعين المتمسكين برسالتهم، عبر التمسك بعلاقة الشعر بالفكر التي هي علاقة لغة الفكر بلغة الشعر، اللغة المرنة والشفافة التي تستعين بكل ما من شأنه الارتقاء بالشعر والوجود. فـبورديو أكد على تأويل كل فعل حسب شروط الانتاج والاستهلاك. فما ينتجه الشاعر بما يستهلكه المتلقي، ويوسع من دائرة معارفه، وتأكيد شروط التأسيس للنمط في الكتابة. وهذا لا يعني الخروج عن دائرة وظيفة النص. فلا شيء خارج النص، كما أكد ديريدا.
رسالة الشعر
بصدد رسالة الشعر نتفق مع من قدم أطروحته التي لا تتعدى الوظيفة الاجتماعية والنفسية والدفاع عن الإنسان والحياة بشكل عام، أي لا يختلف عن وظائف الأجناس الأُخرى، لكنه يتعداها باتجاه الرؤى الفلسفية والكونية بشكل عام. إضافة إلى كل هذا الوظيفة التي تتماس مع اللغة، التي تسللت إلى الأجناس الأُخرى ووفق أبجدياتها، كالتشكيل والسرد والصورة الفوتوغرافية، التي اعتمدت لغتها التي تؤدي وظيفتها في خلق علاقة بين النص والمستقبِل. فمهما اختلفت الأبجدية، فأنها تجتمع في وظيفة تخص المتلقي. وحسب ميلان كونديرا، تكون رسالة الشعر تتجاوز تبصيرنا بفكرة غير متوقعة، بل أنه يقدم لحظة من لحظات الكائن فيحولها إلى لحظة لا تنسى وجدير بحنين لا يطاق. بمعنى يكون متعلق الشعر يتماس مع الخلق والربط بمفردات رؤيوية تدفع باتجاه ملء الفراغات الحاصلة في الوجود. وهذا يتطلب المرونة في كل معينات الكتابة الشعرية بما يحدث نوع العلاقة المستلهمة والموقظة في الذات الإنسانية. ولعل المعينات لذلك؛ الأمكنة والبعد العابر للوجود المادي باتجاه الرؤى الصافية والمختصرة في علاقتها بين الذات والكون، وهي رؤى صوفية، تخص نوع وخصائص التعلق الذي ينم عن التجرد من الاضافات التي ترميها الحياة بكل مكوناتها، مما يتطلب التخلص من المؤثرات المباشرة والانتماء إلى المتعلقات الذاتية المجردة. وهو نوع من الحلول الصوفي في الأشياء ومنها اللغة. وقد أكد الناقد إحسان عباس على أن ظاهرة التصوف هي تعويض عن العلاقات الروحية التي يفتقدها الشاعر في زحمة الوجود، لذا نجده يتمسك بالمعرفي المتنوع من أجل خلق مناخ شعري خاص. وهذا ما يأخذنا إلى ظاهرة التنوع عند الشعراء فهم لا يشكلون طبقة متجانسة، وإنما تتشعب في عالمهم الشعري وفق البعد المعرفي المتشعب أيضاً والمشبع بالتجاوز والإزاحة لكل ما هو مؤثر سلباً في عالمه الشعري الذي أكد عليه هايدغر بربطه بين نشأت الحداثة بالحدث الفلسفي المتمثل في جعل الذات مركزاً ومرجعاً. ومن هذه التوجهات هي ميل الشعراء إلى توظيف الأُسطورة بما يتعدى كونها قناع تميل إليه الأجناس الأُخرى، نحو اعتبارها شكل من أشكال التعبير، ذلك لأنها تستثمر المخزون العاطفي والنفسي، فهي بذلك تساهم في تجديد الالهام وتساعد على التخيل الشعري. إن الأساطير ووعيها الدقيق يشكل أحد الابعاد المعرفية والثقافية التي شكلت شعر الحداثة. لذا نؤكد على رؤية أدونيس المركزة على أن كل ابداع يتضمن بعداً للماضي الذي تجاوزناه، والحاضر الذي نغيره. لعل ما يميز الشعر عن باقي الأجناس؛هو تعامله مع المتن المعرفي بكل أشكاله وأجناسه. وهذا المتن شكّل النسق العام للقصيدة التي مزجت بين المعرفة والرؤية، مما أضفى على الشعر عمقاً دلالياً، وقدرة على التعبير المتنوع من خلال تنوع الأساليب. فالثقافة وعلى حد قول الناقد والباحث د. عبد الرحمن محمد القعود أهم آليات الإبداع الشعري وأدواته. فهي؛ أي المعرفة تدفع إلى الرؤيا والكشف والحفر في ما هو محيط بالشاعر، ومحاولة استجلاء اللامرئي في المرئي. فالشاعر بطبيعة الحال يعيش في واقع معقد يتطلب امتلاك آلية جديدة ومضافة إلى موهبته الشعرية تُسهم في البحث والتقصّي والتمثل بشكل يُحيل الأشياء المرئية إلى متحركات في حاضنة الشعر. فالشعر يُعيد تركيب الأشياء التي قد تبدو مرتبكة في الواقع. ومن خلال هذا التراكم المعرفي ينتج لدى الشاعر وسواه من المبدعين نوعاً من تجدد الرؤية جرّاء تزاحم المعرفة المؤولة إلى تكثيف الدلالة من خلال تنشيط مفردات المعرفة في المتن الشعري وجعلها عاكسة لما تُحققه رؤية الشاعر للكون والحياة والظواهر.