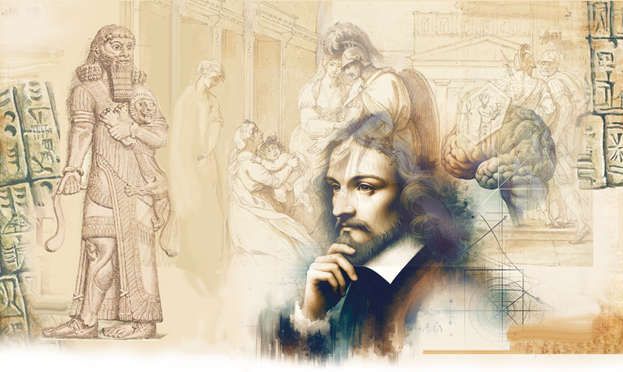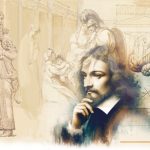علي حسن الفواز

ثمة ما يجعل اللغة مدهشة، فيها من السحر ما فيها من الواقع، وفيها من اللعب ما فيها من الجدّ، وفيها من الإكراه ما فيها من الميوعة، إنّها تفرض علينا هذه النقائض، فتجرنا من الصمت الى الضجيج، ومن العائلة إلى الكينونة.
ما تصنعه هذه اللغة يمكن أن يكون بطولة أو خذلانا، فعبارة “لا شيء خارج اللغة” لا تعني أن الانسان كائن لغويٌّ فقط، بل تعني أن اللغة هي التمثيل العميق والمتعالي لوجوده ومكوثه بتعبير هيدغر، لذا فخيار تأطير هذا الوجود، وتأهيل فكرة الحياة لا يتم الا عبر الإصرار على اللغة، وأن تمثيل صناعة الأثر لا تكون الا عبر البقاء في اللغة، فالتاريخ لغة، والجسد لغة، المقدس لغة، والحب لغة والكره لغة، وعلى النحو الذي يعطى لهذه الثنائيات معان متعددة ومفارقة، يبدو حضورها واستعمالها فاعلا من خلال الاستعارات، أو أن هذه الاستعارات تجعلها تتسع في استعمالاتها، وفي التعبير عن اغراضها وخطابها، وحتى عن اكاذيبها. الحكي من اكثر مهيمنات اللغة اشهارا، وتمثيلا، فهو أداة فائقة الخطورة في تفريغ اللغة داخل انساق، وعبر حمولات، وعلى نحو يفتح للكائن مجالا أوسع للتعرّف على كينونته، أو للهروب منها، فبقدر ما يكون هذا الحكي وجودا يحمل معرفة وخطابا، ويُعبِّر عن سلطة، فإنه يعبر أيضا عن ذات تُفكر عبر الأيديولوجيا، أو عبر الدين، وهو استعمال أيديولوجي بشكل آخر، حتى تبدو اللغة تحت هذا التوصيف المركب وكأنها تمارس وظائف صيانية، بدءا من وظيفة “الحكي الشهرزادي” الى وظيفة “الزعيم السياسي” وليس انتهاء بوظائف الوصايا عند رجل الدين، والتشافي عند الطبيب والاخضاع عند المعلم، وهي وظائف اشهارية لها انساق مضمرة، مثلما لها ايحاءات ظاهرة تدعو الى الاخضاع والتخويف والى اللذة.
الحياة خارج اللغة هي موت رمزي، ليس لأن الجسد/ اللسان يفقد وظيفته، بل لأن المعنى يغيب، وأن تمثيل فكرة هذا الغياب يجعل الجسد بلا وجود رمزي، وبما يجعله يعيش تمثيلا زائفا، لا تكفي الإشارات لصياغة نظامه، أو معناه، فالاشارات بوصفها السيميائي لا تخرج عن اللغة بتوصيف رولان بارت، وبالتالي فإنها ستفرض نوعا معقدا من الاستعمالات الاكراهية، الخارجية التي تجعل الجسد مجال لعبتها، حيث سيعيد صياغة المجازات والاستعارات والكنايات عبر قاموس من الصعب فرض تداوله، الا بحدود سرية، أو رمزية، فالسيمياء خارج اللغة تتحول الى فن معقد، والى ضاغط يهدد وجود الكائن وقدرته على التعرف، وحتى على التجاوز وخرق المألوف..
أنا أفكر باللغة إذا أنا موجود
هذا “الكوجيتو” الديكارتي هو جوهر استعمال اللغة، وسرها العميق، فالحديث عن التفكير خارج اللغة سيكون ملتبسا، وغير صالح لصناعة بطل أو حكواتي، وأحسب أن كل الابطال الذين نعرفهم تاريخيا أو مثيولوجيا كانوا ثرثارين، وصانعو بلاغة وتوريات واقنعة، وأن علاقتهم بالتلقي والاصغاء كانت خاضعة الى مركزية اللغة، وحتى مفهوم المريد في الصوفية كان يرتبط ب”الشيخ” عبر احالات أو ايحاءات، تجد في تكثيف الدال اللغوي قوة رمزيتها في تمثيل المدلول، وفي التعالق العاطفي، وحتى في التابعية والحلول.
التفكير في اللغة هو تحريض على مواجهة النسيان والغياب، على نحوٍ يجعل من استعمال اللغة، خاضعا الى شروط خارجية تخص التواصل بها، أو الى شروط داخلية تخص التماهي والعظة والصلاة، أو الى شروط تمثيلية تخص الكتابة، بوصفها أثرا أو بحثا عن الاشباع الرمزي، أو بحثا عن الخلود، فكلاهما يتمثلان فكرة مواجهة الموت، وتقديم اللغة بوصفها قوة لصيانة الكينونة، والحدّ من نسيانها، فاللغة تتحول الى لعبة بتعبير فيتغنشتاين الذي ينظر الى اللغة بوصفها مجالا تحليليا تؤديه “ مجموعة من الأنشطة والأساليب التي يمارسها الناس، فهي ليست نظاما ثابتا” وبقدر ما كانت هذه النظرة منطقية، فإن ما طرحه هيدغر بوصفه رائد فلسفة الاختلاف يؤكد على أهمية التعالق بالعالم من خلال ممارسة النقد، والتعرف على فضاءات اللغة من خلال التفكير بالأشياء بوصفها ظواهر، تستدعي الفهم والتأويل، وإعادة النظر ب”صرامة الأفكار” وبما تصنعه الأيديولوجيا من “وعي زائف” كما يقول ماركس، فإعطاء اللغة قوة التعلم والكشف، يعني اعطاءها قوة “ النظر الى الأشياء التي يتمثلها وجوده” والتي لخّصها فتغنشتاين بعبارة “حدود عالمي هي حدود لغتي”.
قد تكون فكرة ديكارت عن اللغة لا تخرج عن “العقل” لكنه أرادها بالمقابل أن تكون طاقة محرضة على التفكير، وعلى أن يكون هذا التفكير منهجيا، لأنه تعني التمكن من “ الاستمرار والبحث عن الحقيقة دون ان ينتابنا خوف من الفشل والتعثر” كما يقول إبراهيم ماين.
التفكير في اللغة ليس بداهة، ولا عشوائيا، فبقدر ما يربطه الفلاسفة بالمفاهيم، فإن اللغة ستظل مثارا للتساؤل، وأن الشك فيها، يدفع باتجاه “البحث عن الحقيقة” أو “البحث عن الغائب” وعبر إعطاء اللغة أهمية قيامها بوظائف الكشف، والتعرف، وهو ما فعله “حي بن يقطان” و”روبسن كروسو” إذ اخضعا الوجود والطبيعة والحصول على اللغة من خلال المعرفة الحدسية، وصولا الى ما صنعته السرديات في زمن لاحق، حيث لعبت الرواية بوصفها مجالا للحكي دورا في معرفة العالم، وفي التعرف على ما يخفيه التاريخ، أو ما تخفيه الاساطير والأديان.
اللغة التي تفترس الكائن
استعمال اللغة يعني استعمال الأفكار، ومواجهة صمت العالم، حيث تتبدى اللغة بوصفها سؤالا أو خطابا أو تمردا، أو افتراسا للماضي أو للتاريخ الذي تصنعه السلطة أو الدين، فتؤدي اللغة وظائف خارقة عبر السرد والتخيل والاستعارة والتورية والقناع، وحتى عبر صناعة الرموز والاشارات والايقونات..
افتراس اللغة في هذا السياق هو تشهٍ للعالم/ الوجود، إذ تحمل اللغة سلطة مضادة، ليس عبر الكراهية والمحو، بل عبر “ المعرفة” بوصفها شغفا وفهما وتأويلا ورؤية، وعبر تزجية اللذة من خلال ما تصنعه اللغة من توصيفات للجسد والمكان والطعام والحرب والانثى وغيرها، فهذه التوصيفات لا تعني الحفاظ على الحقيقة المتخيلة فحسب، بل تعني الاستمرار في البحث عنها وتجديدها، إذ لا توجد حقائق ثابتة بتوصيف نيتشه.
يتحول البحث عن الحقيقة الى إزاحة كبرى، وربما الى عملية طرد كبرى، فالخروج عن الثابت، يعني فكرة الخروج الاولي من الكهف للتعرف على الطبيعة، وللتعرف على المعبد والمدينة فيما بعد، وصولا الى اكتشاف اللغة، للتعبير عن الذات وعن الحاجة والوجود، ولمواجهة الموت، فخارج اللغة يكون العالم صامتا، وأن تخريب هذا الصمت لا يكون الا عبر اللغة، وعبر ما تصنعه من أدوات ووسائط لافتراس العالم، عبر الحكي والتدوين، أو عبر العبادة والملحمة والاسطورة، وعبر الحكايات التي ارتبطت بنشوء المدن، والملوك والالهة، حدّ أن هذه النشوءات ارتبطت بحكواتيين كبار، لهم مهارة ومعرفة اللغة، فهوميروس كان يحكي، وهناك من يدوّن، والسومريون جعلوا من ملحمة كلكامش حكاية لخلود الانسان عبر اللغة والعمل، والبابليون جعلوا من “اسطورة الخلق البابلي” نصا في حكاية البطل وموته، وعلاقته بالخصب والوجود، لأن وجود البطل والخصب والاله كان يعني لهم وجود المستقبل.
كلّ ما يتعلق بالسرد يتعلّق بالافتراس، لأن السرد يعني التوظيف المتعالي للغة في صناعة الوجود، وفي تدوين التاريخ، وهو ما يجعل الحديث عن تاريخ المركزيات الكبرى رهينا بحيازتها على قوة لغوية، أي أجهزة تدوين سردياتها، في السلطة والدين والسياسة والمقدس، وحتى في صياغة مفاهيم الهوية والتاريخ، وصولا الى عصورنا الحديثة التي تحولت فيها مركزية الغرب الى قوة طاردة، عبر الغزو والاحتلال والاستعمار، فعمدت الى فرض سردياتها، بوصفها أدوات لافتراس الآخر، واحسب أن اشد تمثلات الافتراس فتكا جاءت مع “الحداثة” التي أعطت للامبريالية قوة فائقة، واعطت التبشير والاستشراق قوة عميقة، اعادت من خلاله وضع اللغة في انساق اكراهية، ارتبط بعضها بفلسفة القوة والعنصرية، وبعضها الاخر ارتبط بالاستعمار والاحتلال والعنصرية، مثلما ارتبط بعضها بسرديات التحرير والثورة والبحث الثقافي عن الذات والهوية، وباطروحات ما بعد الكولنيالية والاستشراق بمنظور ادورد سعيد، حيث أعاد اكتشاف الذات من خلال العودة الى الهوية والمكان واللغة، اللغة هنا مجالا للتفكير ولصناعة “السرديات المضادة”.
لقد عمد “العقل الغربي” على فرض خطابه، ليتحوّل الى “اكبر مصيدة كولنيالية في تاريخ الحيوان البشري” بتوصيف فتحي المسكيني، وهذا الفرض تحوّل هو الآخر الى سلطة لها فرضياتها وسردياتها في عالم القانون والاقتصاد والأمن والسياسة، وفي التعليم الذي تقوّضت مركزيته اللغوية، ليكون بابا مفتوحا للآخر الذي حاول أن يوظف “الاحتلال” بمعناه السياسي والجغرافي والثقافي لجعل لغته مركزا موازيا، كما في الفرانكفوية، أو مركزا مُقلقا كما في الانكلوفونية، حيث يتعمد الى فرض ما يشبه الاغتراب اللغوي، من خلال افقاد المركز اللغوي العربي سطوته أمام مركزية لغة الآخر، وأمام مركزيات ثانوية تصنعها الثقافات المحلية، والتي تمثل في جوهرها هويات محلية لها مخزنها القومي والطائفي والقاموسي، ولعل اكثر تمظهرات اللغة التي تحولت الى مركز عصابي سردي، كانت عبر الكيان الصهيوني الذي جعل من اللغة العبرية مجالا لافتراس للمكان والتاريخ، فأعاد صياغة المحذوف من سردياتها، للترويج لفكرة الكيان، ليكون صالحا لاستعمالات القوة والكراهية والعنف، ولصياغة زمن سياسي جديد في الشرق الأوسط، يقوم على أساس اسطرة الجغرافيا، وعلى إيجاد أطر أو علاقات تربطها بالأقلمة السياسية، والمركزية الأمنية، والتي تفترض قيمومة وجودها الطارد على أساس محو “الغير” وادخاله في حروب محلية، طائفية وقومية وشعبوية، مع التعمد الى حذف الأصول من سردياته الثقافية والانثربولوجية، بما فيها سرديات الذاكرة والاسطورة والحكي والطعام والقصص، وكلها تنتمي الى مرجعيات ما تصنعه اللغة من شواهد وآثار غاطسة في اللاوعي الجمعي.