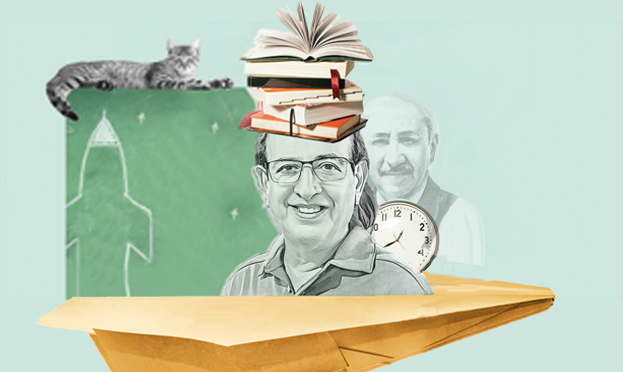علي حسن الفواز
تنجذب قصص خضير فليح الزيدي الصادرة عن “دار السرد/ بغداد 2025 إلى عوالم فارقة، تمزج بين الواقعي والغرائبي، ليس لتجاوز هذا الواقعي، بل لمواجهته، والغوص فيه عبر ذلك الغرائبي، حيث تتبدى لعبتها السردية وكأنها تقوم على تتبع مصائر شخصيات مضطربة، لكنّها حيوية في تمثيل الغرائبي في واقعها، وهذا ما يدفع إلى التعاطف معها، والتعرف على ما يجري في خفايا الواقع من خلالها، كاشفة عن معاناتها، وعن قسوة فقدها، وعن ما تتعرض له من اغتراب عميق، ومن واقعٍ يمور بنكوصات صراع وجودي، تحضر فيه تلك المصائر الباحثة عن حريّتها، وكأنّها تحلم بالتمرد على واقعها.
تبدو قصص الزيدي ساخرة وهي تعيش غرائبية تحولاته، مسكونة بهواجسها المذعورة، واحساسها بالفقد، حتى يبدو القص قريبا من “لعبة فتغنشتاين” عبر توظيف اللغة التي تلعب دورا فارقا في تمثيل المصائر، من خلال رغبة المؤلف ذاته، في اصطناع سرديات مكثفة لها، يتمثلها عبر الاغتراب بوصفه النفسي والفلسفي، فالحدث الواقعي يتحول إلى مناصة سردية، والاحساس به يتحول إلى قطيعة، تناقض الواقع، وتستفز المكبوت فيه، فيتشظى عن حكايات أو عن “قصص قصيرة” تقوم على شطارة استدعاء الحكواتي، الساخر والساخط، والمتواري خلف وعي استقصائي، وعي المراقب الذي يرقب العالم الخارجي من خلال “عدسة ذكية” تتضاءل أو تتضخم فيها الملامح، لكنها لا تفارق خيار السارد وهو يتقصد تقديم شخصياته من خلال سردياته المفارقة.
لا وظائف للشخصيات سوى تعرية الواقع، وجعل الغرائبي اكثر تمثيلا لليومي، فبقدر ما هي شخصيات مصدومة ومستلبة، فإنها تكشف عن وعي مفارق بأزمتها واغترابها، يستدعى لها القاص ما هو رمزي، لتسويغ صراعها مع ذلك الواقع، ومع الحاجة إلى الحرية في تمثيل وجودها المضطرب، حتى يبدو عنوان المجموعة “خالي فؤاد التكرلي” وكأنه تورية مركزية لابراز تقانة هذا التمثيل، ومحاكاة رمزية مشفرّة يستدعي من خلالها القاص قناع الكاتب “القاص الغائب” إلى لعبة القص، بوصفه معادلا سرديا لاستدعاء الحكواتي، وبما يجعل من المجاورة السردية بينهما مأخوذة بالموازنة بين الواقعي والغرائبي، وبين استعارة ما هو واقعي نقدي عند “فؤاد التكرلي” وبين ما هو ساخر في الواقع العراقي، الذي يتحول إلى “واقع سحري” له تمثلاته الوجودية، واحالاته النفسية، وله تسريباته النسقية التي تنهل من صاحب قصص “العيون الخضر” كثيرا من واقعيته النقدية.
سردية الجملة القصصية وكثافتها من اكثر العلامات التي تؤشر طبيعة قصص المجموعة، إذ تغتني تلك الجملة بسهولة سردية، تتشبّع ببعد نفسي، يعكس تمثيلها للصراع الداخلي الذي تعيشه الشخصيات، فهي تشبك بين اذلك الصراع الداخلية عبر- المرض، الخوف، القلق، الخذلان- وبين وجودها الاغترابي/ الزمني، وعلى نحوٍ يتحول فيه هذا “الشبك” إلى مشاهد غائمة، لها توريتها، ولها اقنعتها الرمزية في إخفاء ما تعانيه من الخيبة والاحساس بالفقد، فضلا عن شغفها باستدعاء المفارقة، حتى تبدو وكأنها معادل نفسي لأزمة تلك الشخصيات، فيكون لجوؤها إلى “التأويل والتلويح والتلميح” محاولة في فك احتقانها السردي، وفي ترميز قصصها ـ غير البريئة ـ عبر انساق مضمرة، توحي بصور الخراب الذي تعيشه على مستوى الواقع، أو على مستوى ذواتها المأزومة والمعذبة.
القص بين الواقع والاقنعة
في قصة “وعكة نفسية” يستعير القاص صوته الداخلي أو قناعه الشخصي، عبر استدعاء شخصية فصامية، تعيش غرائبيتها مع المجتمع، لكنها تبحث عن ذاتها، فلا تجد سوى مزيد من الاغتراب العميق، وهو ما يدفعها للذهاب إلى مشفى الامراض العقلية، بحثا عن اسرار أزمتها، بوصفها شخصية قناعية يتلبسها كاتب القصص الذي يواجه مع مدير المشفى اختيارات مفارقة، تُدخله في لعبة سجالية تتحول فيها اللغة إلى اداة الكشف عن فصام وجودي يعيشه الجميع- الطبيب وكاتب القصص-، وأن ما يختارانه من أبراج، أو ما يتحاوران به حول العقل ومحنته، يكشف عن محنة الواقع العراقي، بوصفها محنة فقد واغتراب، فلا يجد “البطل/ كاتب القصص المسلية” الا المشفى للاعتراف، لكي يتخلص من كوابيسه، ومن الآخرين الذين يدفعونه للهروب من الواقع الدوستوبي إلى المشفى اليوتيوبي.
تحمل شخصية “بلقيس” في قصة “الأخت الكبرى” مفارقتها من خلال التمرد على نمطية الأنثى العانس، وعلى تقويض علاقتها بالزمن، والإسقاط الجنسي، لتجد في القراءة اشباعا رمزيا، لمواجهة مفارقة الصراع بين حلمها الذي تصنعه رمزية القراءة، وبين الواقع ومفارقاته الذي يتمثل تناقضاته “مجتمع المعلمات” و”مؤسسة الزوج الذي يكره الكتب” وعلى نحو يجعلها اكثر وعيا بأزمتها الوجودية، واسقاطاتها النفسية والجنسية، حيث يتقوّض “سلطة الزوج/ البطل الجنسي” مقابل تنامي فكرة الحرية/ الطلاق، وعبر تضخم قوة الذات عبر مواجهة اغترابها، وعبر تجاوزها عقدة الخيبة والسقوط كما في قصص التكرلي.
وفي قصة “بائع الأحذية” يتحول هاجس الحرية إلى قوة غامضة، تدفعه إلى مواجهة أزمته الداخلية، واحساسه بالاستلاب، من خلال اشباع سردية التحول، فما يعرضه البطل في “معرضه الشخصي” يبدو وكأنه نوع من التفريغ النفسي، والاحساس بالإشباع المتعالي، وربما بمواجهة الهامش الذي كان عنوانا لانسحاقه الوجودي..
في قصة “المرعب” تأخذنا اللعبة إلى أزمة “الشخصية” وهي تعيش صراعها الداخلي، تبحث عن ذاتها من خلال المغايرة، لكنها تصطدم بالواقع، مما يدفعها إلى ما يشبه الاغتراب/ الموت، حيث قمع الجماعة/ فكرة الهيمنة، وحيث الخضوع إلى رمزية القوة التي يصنعها الآخرون، وكأن القاص أراد أن يقدم لنا انموذجا “سايكوباثيا” للصراع الوجودي في الواقع العراقي، حيث يتوزع هذا الصراع بين العنف الرمزي لسلطة الجماعة وتأويلها، وبين الأنا المسحوقة تحت لعنة قناع التسمية وذاكرتها اللاوعية.
كما تكشف قصة “المتردد” عن متاهة الشخصيات، الأولى تعيش عبثها من خلال اضطرابها الداخلي، وقلقها، والثانية تعيش اغترابها عبر “اسمها” وعبر ما تتخيله من أوهام مثالية حول “ الأرصاد الجوية”، والثالثة تعيش غرائبية علمانياتها..
الواقع.. سرديات القص
واغتراب الشخصية
التقاطع بين الشخصيات يوحي بأزمة وجودها في الواقع، وفي غرائبية تحولها، إذ تعيش اضطراب أحوال الجو، كتورية لاحوال التشوه في المكان، وفي لإحساس بأن هذا المكان قد تحول إلى دوستوبيا خاضعة إلى العبث والوهم، وهما خياران يعكسان مدى التشوه الذي باتت تعيشه الشخصية العراقية، إذ يتحول اغتراب الموظف المتردد والمتقاعس”جمال خيون” إلى قناع مشوه في شخصية “رخة مطر بن صيف” التي تعيش اغترابها عبر أوهام خرافاتها وغرائبية طقوسها، وضديتها مع شخصية “السيد زوبعة” العلماني الصاخب بأفكاره وتنبؤاته عن المناخ والبايولوجيا..
ومن القصص الجميلة في المجموعة قصة “ سيناريو محتمل عن ليلة الجمعة” إذ يقودنا القاص إلى لعبة التخيل ذي الاحالات الجنسية، وإلى رمزية “الخميس” في اللاوعي الشعبي، وإلى طقوسها وشغفها، لكن اكتشاف الزوجة لعجز الزوج المبتور الساقين، يضع البعد الغرائبي للسرد نظيرا لغرائبية الواقع، في ادانة واضحة للفقد بمعناه النفسي/ الاشباعي، وإدانة للحروب التي وضعتها أمام تشوهات الجسد وضياعه وعجزه..
تفتح قصة “لحم طازج” ثيمة “المسكوت عنه في عالم السينما، حيث يتحول الاستغلال الجنسي إلى استغلال وجودي، وإلى تمثيل علاقات مشبوهة، تغترب فيها الشخصية عن حريتها في الحب والعمل، مقابل بروز الاستغلال كثيمة لرمزية السلطة التي يمثلها المخرج، الذي يختصر الجسد الانثوي إلى “لحم طازج” لذكورة تعمد إلى تشويه الواقع عبر غرائبيته، وعبر تهميش هذا الجسد من خلال استلاب مقاومته.
في قصة “وذلك الذي لا يُسمّى” يفتح القاص مقموعا رمزيا، له احالاته النفسية والاجتماعية، فمرض السرطان يتحول إلى تابو، يطرد التسمية، ويقوّض الوجود عبر الفقد، وبما يجعل شفرته وكأنها تمويه رمزي لفكرة الموت، ولعزل الكائن عن اشباعات لحظته الحسية، وعن احساسه بالاكتمال، وكأن القاص أراد أن يضعنا أمام مفارقة الحياة والاحساس الغرائبي بالموت، وأمام ضآلة ذلك الكائن الذي يجد نفسه مسكونا بإحساس الفقد والعجز والهشاشة.
ما يميز قصة “خالي فؤاد التكرلي” وهي القصة الأخيرة في المجموعة هو تعمد القاص إلى توظيف قناع التكرلي، عبر ثيمة القصة الداخلية التي أراد نشرها “الراوي” ليجد نفسه أمام ازمة الواقع واستلابه، مسكونا بصراعاته العميقة، وبنظرته الغرائبية لقيم الحرية والشرف والحب والجسد، وبهذا التمثيل السردي اعادنا القاص إلى “واقعية التكرلي النقدية” وهو يكشف عن المقموع الاجتماعي والنفسي، وعن نظرته لقضية الزنا والثأر، عبر توظيف تقانة “ الميتاقص” والتوازي الزمني بين حدثين مفارقين، وكأن القاص أراد من هذه الاستعادة توسيع بعدها الرمزي، والكشف عن جوهر ازمتها، وعلى نحوٍ يجعلها تتسع لنقد الرثاثة الاجتماعية وأنموذج شقاوته، كقناع لنقد الواقع السياسي، والسخرية منهما..
تهجس قصص هذه المجموعة بفرادة أنموذجها، فبقدر تمثيلها لليومي والنفسي، الا أنها أعطت لفكرة الحكاية بعدا تعمد القاص من خلاله الاثارة، على مستوى توظيف اللغة وحساسيتها التصويرية، أو على مستوى البناء الاسلوبي ذي التمثيل الاستقصائي، ففي بعض القصص نجد نوعا من التوالي السردي الذي اعطى لها حضورا في تتبع تمثيل فرادة القص، وفي ابراز خصوصيته، عبر ما تستدعيه من أسلوب للقاص الحكاء، أو للأسلوب الذي يعمد اليه صاحب العين الاستقصائية، أو عين الكاميرا ليرصد من خلالها المخفي والغامض والهامشي، والمتواري خلف اغطية الواقع الخشنة، وعلى نحو يجعل من الغرائبي وكأنه تمثيل للسرد الضد الذي جعل من القاص يمارس وظيفة اللاعب السردي اكثر من أي وظيفة أخرى.